 06-16-2022, 04:15 AM
06-16-2022, 04:15 AM
|
|
|
|
|
 واقعية اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم
واقعية اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام الأتمَّان الأكملان على شفيع الأنام؛ محمد بن عبدالله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا.
وبعد:
فأقول وبالله التوفيق وعليه توكَّلت: إن من مقتضى العرفان بالجميل، والوفاء بالعهد لهذا الدين العظيم: أن يثوب إليه أبناؤه، وأن يجهدوا بالدعوة إليه، وأن يعلنوها صريحةً واضحةً: إنِ الحُكمُ إلا لله.
كما وجب عليهم أن يعرفوا أن الفقه الإسلاميَّ ليس بذلك النظام الذي يرفض كلَّ حديث لحداثته، وكلَّ جديد لجدته، بل إنه يتناول الأمور والمسائل باعتبار الواقعية والمصلحة، ويستقطب كلَّ تغيير، ويدفع به إلى مختبره ليقيسه بمقياسه الخاص، ويزنه بميزانه الدقيق الحسَّاس، فما وافق الكتابَ والسُّنة والأصول العامة التي يدعو إليها، وضعه في قالبه وأعطاه صفةَ الإباحة والمشروعية، وما نافى تعاليمَه العامة والخاصة، وما خرج عن نطاق إطاره العريض، أبعَدَه عن الساحة الإسلامية والصبغة الدينية.
ويبقى الاجتهاد ميدانًا فسيحًا لذوي البصيرة النافذة والفكر الثاقب، وهو النبع الثَّر للفقه؛ به تغنى الشريعة وتزدان، وتستمرُّ وتزهو، ويُكتب لها الخلود والبقاء، وبه تُدرك أسرار الشريعة، ودقائقها البديعة.
والاجتهاد في الإسلام بمثابة الباب المفتوح أمام العقل المسلم؛ ليفكِّر بحرية كاملة، وبحصانة معزَّزة، بعد أن يتسيج بسياج الإيمان والعلم، ويعتصم بسور منيع من التقوى والرهبة لله، ويجتنب الهوى والرياء والنفاق، فيكيِّف كل معطيات العصر تكييفًا إسلاميًّا، وينظر إليها من زاويةٍ عادلةٍ محورُها العقيدة والشريعة.
فما مفهوم الاجتهاد لغةً واصطلاحًا؟
هل النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاجتهاد فيما لا نصَّ فيه؟
أين تتجلَّى واقعية النصِّ في اجتهاد النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟
وللإجابة على هذه الأسئلة اتبعت التصميم والترتيب الآتي:
تصميم العرض:
مقدمة:
المحور الأول: مفهوم الاجتهاد لغةً واصطلاحًا، والعلاقة بينهما.
المطلب الأول: مفهوم الاجتهاد لغة واصطلاحًا.
المطلب الثاني: العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي.
المحور الثاني: اجتهاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
المطلب الأول: أدلة منع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم.
المطلب الثاني: أدلة جواز اجتهاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
المحور الثالث: أمثلة لبعض المواقف التي تبين واقعية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم.
المطلب الأول: بعض الاجتهادات المتعلقة بالمصالح الدنيوية.
المطلب الثاني: بعض الاجتهادات المتعلقة بالمصالح الدينية.
خاتمة.
المحور الأول: مفهوم الاجتهاد لغةً واصطلاحًا، والعلاقة بينهما
المطلب الأول: مفهوم الاجتهاد لغةً واصطلاحًا:
الاجتهاد لغة: مأخوذ من الجهد بفتح الجيم وضمها، وهو المشقَّة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ [الأنعام: 109]، وقد ورد في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، كلُّها تدل على الاجتهاد، وهو بذلُ الوُسعِ والطاقة، والمبالغة في اليمين.
يقول ابن منظورفي لسانه: الاجتهاد والتجاهد: بذلُ الوسع والمجهود؛ فالاجتهاد بذلُ الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال من الجهد، وهو الطاقة[1].
ويقول الزبيديفي جواهره: هو بالفتح الجهد، وهو المشقة، وقيل: المبالغة والغاية، وبالضم: الوسع والطاقة، وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة[2].
ويقول ابن فارسفي مقاييسه: جهد: الجيم والهاء والدال، أصله المشقَّة، ثم يحمل على ما يقاربه، يقال: جهدت نفسي وأجهدت، والجهد الطاقة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ [التوبة: 79][3].
والذي يُستنتج من هذه التعاريف اللغوية أن الاجتهاد يستعمل بمعنى الوسع والطاقة، ويستعمل في بلوغ الغاية في الطلب والسعي، وفي المشقَّة والمبالغة.
الاجتهاد اصطلاحًا: لقد حاول علماء الأصول أن يعطوا تعريفًا للاجتهاد يناسب تخصُّصهم الأصولي؛ فكل واحد منهم عرَّفه من زاوية نظره، استنادًا إلى آلية الاجتهاد نفسه، وربما اختلفت العبارات في تعريفه وتنوَّعت، أو ضاقت أو اتَّسعت، ولكنها في جملتها لم تخرج عن مدلولاتها وسياقاتها، ولنوضح ذلك نذكر من هذه التعريفات على سبيل المثال لا الحصر:
تعريف الغزالي في المستصفى: الاجتهاد: هو بذل المجتهد وُسعَه في طلبه العلم بأحكام الشريعة [4].
ومعناه أن يعطي المجتهد كلَّ ما في طاقته وقدرته؛ قصد العلم بأحكام الشريعة.
أما القاضي البيضاوي فقد عرفه بأنه: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية[5].
ومعناه: أن يستفرغ كلَّ مساعيه؛ قصد نيل وفهم وبلوغ الأحكام الشرعية.
وعرَّفه كذلك ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسعَ لتحصيل ظنٍّ بحكمٍ شرعي[6].
ومعناه: أن يبذل الفقيه قصارى جهده وسعيه؛ قصد استخراج واستخلاص ظن بحكمٍ شرعيٍّ.
وعرَّفه كذلك الإمام الشيرازي: بأنه بذل الوسع، وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعيِّ، ممن أهلٌ للاجتهاد[7].
ومعناه: أن يزاوج المجتهد بين الوسع والمجهود، في طلب الحكم الشرعيِّ، وأن يكون ممن توفَّرت فيه شروط الاجتهاد، وإلا فلا يمكن عدُّه مجتهدًا، وإن أفرغ الوسع والطاقة.
وأخيرًا عرَّفه الكمال بن الهمام بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعيٍّ، عقليًّا كان أو نقليًّا أو ظنيًّا أو قطعيًّا[8].
ومعناه: أن يبذل الفقيه قدرته في استخلاص الحكم الشرعيِّ، سواء عدَّ هذا الحكم من العقليات أو النقليات أو الظنيات أو القطعيات.
والذي نميل إليه من هذه التعريفات، تعريفُ الكمال بن الهمام؛ لكونه لم يضيق دائرة الاجتهاد، فأدخل فيه جميع أنواع الأحكام؛ فهو الأنسب؛ لكونه أعم وأشمل من غيره من التعريفات.
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:
إن المعنى الاصطلاحيَّ لم يبتعد عن المعنى اللغويِّ، كما هو واضح من ذكر التعريفات؛ فالتوافق ظاهر، ونقطةُ الالتقاء بينهما واضحة، وهي المبالغة في كلا الاستعمالين[9].
أضف إلى ذلك أن المعاني اللغوية لها بالمعنى الاصطلاحيِّ علاقةٌ وطيدة؛ ذلك لأن الفقيه المجتهد يبذل وُسعَه وطاقته في طلب استنباط الحكم من الأدلة أو من قواعد الشريعة الكلية العامة، وهو يبالغ في ذلك لدرجة المشقَّة والاجتهاد، وهو يبلغ الغاية في الطلب لا يألو[10].
المحور الثاني: اجتهاد النبيِّ الكريم صلى الله عليه وسلم
من الواضح أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم يجتهد في العديد من القضايا، وهذا الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام إمَّا أن يكون عن وحيٍ من الله عز وجل، وإمَّا أن يكون اجتهاده بدون وحي، وفي هذه الحالة لا يقرُّه الله تبارك وتعالى على اجتهاده إذا لم يكن صوابًا.
واختلف العلماء في هذا المضمار اختلافاتٍ يمكن أن نجملها في ثلاثة أقسام:
• ذهب أغلب رجال أهل السُّنَّة إلى جواز تعبُّد النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأساس الاجتهاد، وفي هذا السياق يقول الجويني رحمه الله: "ذهب الذين أحالوا التعبُّد بالقياس إلى الجري على مقتضى أصله في استحالة التعبد بالقياس، فأمَّا القائلون بالقياس، فقد اختلفوا أيضًا؛ فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز تعبُّد الرسول صلى الله عليه وسلم بالقياس والتحري والاجتهاد، ومنعوا ذلك عقلًا، وذهب آخرون إلى جواز تعبُّده بالاجتهاد والقياس، وألحقوا ذلك بجائزات العقول، وهذا الذي نختاره"[11].
• وفي المقابل مال البعض إلى ردِّ هذه الآلية في حقِّه، كما هو منسوب إلى بعض الشافعية، وكما نسب إلى بعض المعتزلة، كأبي عليٍّ الجبائي، وابنه أبي هشام، وما استدلَّ به هذان الأخيران من منع اجتهاد النبيِّ صلى الله عليه وسلم - دليلٌ امتاز بكثرة دورانه على ألسِنَة الناس، وهو في واقع الأمر ليس بدليل، وهذا الدليل هو التمسُّك بقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ [النجم: 3]، فقد اقتطع الجبائي هذه الآية عن سابقتها ولاحقتها، وقذف بها في آذان الناس، فصارت تلوكها ألسنتهم بدون فكر ولا رويَّة، والعجيب أن كثيرًا ما نسمع مَن يستدلُّ بها حتى الآن من بين طلاب العلم والعلماء[12].
• بينما اتجه فريق ثالث إلى التوقُّف أو عدم القطع؛ لتعارض أدلة الفريقين، وعدم وضوح الترجيح بينهما؛ كالهمداني وأبي الحسين البصري، والغزالي[13].
وإن كان الغزالي قد استبعد وقوع الاجتهاد من النبيِّ صلى الله عليه وسلم في القضايا الدينية، واستظهر أنه كان يعمل طبقًا للوحي الصريح من غير اجتهاد[14].
أما الشيرازي، فقد ذهب إلى "جواز الاجتهاد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدلَّ بأنه عليه الصلاة والسلام أمر سعدًا أن يحكم في بني قريظة[15]، فاجتهد بحضرته، ولأن ما جاز الحكم به في غيبته، جاز الحكم به في حضرته كالنصِّ؛ فالرسول صلى الله عليه يجوز له أن يجتهد في الحوادث، فكما أن للعلماء أن يجتهدوا؛ فالنبيُّ الكريم أحرى وأَولى، وقد كان الخطأ جائزًا عليه إلا أنه لا يُقَرُّ عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ﴾ [التوبة: 43]، فدلَّ على أنه أخطأ؛ لأن مَن جاز عليه السهو والنسيان، جاز عليه الخطأ كغيره"[16].
وأهمُّ ما يفرق بين اجتهاد النبيِّ عليه الصلاة والسلام واجتهاد علماء أُمَّته هو أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم محروس ومؤيَّد بوحي الله تعالى، فلا يُقَرُّ على خطأ، ومن هنا فهو حُجَّة في الدين، ويَحرُم مخالفته، وليس ذلك لاجتهاد علماء أُمَّته، اللهمَّ إذا كان اجتهاد علماء الأُمَّة في عصرٍ من العصور وأجمعوا عليه، فيحرم مخالفته"[17].
وقد ذكر الغزالي أنه "دلَّ الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة الاجتهاد الصادر عن النبيِّ الكريم، كما دلَّ على تحريم مخالفة الأُمَّة كافة، وكما دلَّ على تحريم مخالفة اجتهاد الإمام الأعظم والحاكم؛ لأن صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام والحاكم وكافة الأُمَّة، كذلك النبي الكريم"[18].
المطلب الأول: أدلة ردِّ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم:
لما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قادرًا على كشف اليقين، بالأخذ عن الوحي؛ لذا فلا مجال للقول باجتهاده، باعتبار أن الاجتهاد عمل بالظنِّ، ومن القبح العمل بهذا وترك الوحي واليقين.
لو جاز للنبيِّ صلى الله عليه وسلم الاجتهاد، لكان يجوز مخالفته باجتهاد غيره، مع أن هذا يُبطل الغرضَ من بعثته إلى الناس، وهو واضح الدلالة.
جاء في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، وحيث لا يقال للاجتهاد: إنه صادر عن وحي، أو إنه وحي؛ لذا لم يصدر عن النبيِّ اجتهاد قط[19].
المطلب الثاني: أدلة جواز اجتهاد النبيِّ صلى الله عليه وسلم:
المجوِّزون لاجتهاد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في حدود ذلك وشروطه؛ فمنهم مَن اشترط جوازه في حدود المصالح الدنيوية من الحرب والسياسية، ومعرفة الوقائع الجزئية ليطبق عليها الكليَّات كما هو الحال في القضاء، ومنهم مَن جوَّز الاجتهاد على النبيِّ صلى الله عليه وسلم مطلقًا، يعني بما في ذلك القضايا الدينية[20].
ومما استدلُّوا به قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]، ووجه الاستدلال بالآية أن المشاورة إنما تكون فيما حكم فيه بطريق الاجتهاد؛ إذ لا مشاورة فيما نزل به وحي، ولا ريب أن المشاورة أمرٌ له بالاجتهاد لاستظهار آراء مَن معه من المؤمنين؛ ليختار منها باجتهاده ما يراه عليه الصلاة والسلام موافقًا للمصلحة، وهذا هو الاجتهاد المطلوب، وقول مَن قال: إن الآية واردة في الحروب، لا يمنع من ثبوت الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم بها؛ إذ الحروب جهادٌ في سبيل الله، وهي أحكام شرعية[21].
المحور الثالث: واقعية اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم
كيف السبيل إلى عموم الشريعة، والنصوصُ مهما كثرت محدودة، والحوادث على مرِّ الأيام متجددةٌ غير مضبوطة؟ فلو وقف التشريع عند حرفية النصوص، لوقَعَ الناس في الحرج، بعد أن تفضَّل سبحانه بنفيه عنهم: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، ولن تسع الشريعةُ الناسَ وحوادثهم إلا بأمرٍ وراء هذا، هنا أذن لهم في الاجتهاد، وعلَّمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقته بعد أن تقدَّمهم في هذا السبيل؛ كيلا يكون عليهم حرج فيه، والاجتهاد بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من عبارات النصوص وإشارتها ومعانيها[22]؛ لهذا كان لا بد من الاجتهاد، من أجل مسايرة الواقع، وتقديم إجابات شافية كافية للمستجدات والنوازل التي تطرأ وتحدُثُ في كل وقت وحين، والتحرُّر من التقليد والتبعية، وذلك بالتفرقة بين ما هو وحي، وبين اجتهادات البشر التي طغت على النصِّ، واعتبرها الكثيرون مقدَّمة على النصِّ، بقصد أو من غير قصد؛ لهذا كان لزامًا علينا استيعاب المنهج الصحيح والقويم، الذي رسمه لنا صلى الله عليه وسلم، والاقتداء والتأسِّي به؛ حتى لا نتخبَّط في متاهات الوهم والضلال، ونزيغ عن الحقِّ والصواب، وندرك أن من بين ما روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، وما سبيله سبيلُ الرأي والاجتهاد، وفيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا بشر؛ إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر))[23]، وذلك فيما يخضع لتجارب الإنسان وخبراته، وما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، منه ما يستند إلى الوحي فقط، ومنه ما يستند إليه في بعض الأمور، وإلى الاجتهاد في البعض الآخر منها[24].
المطلب الأول: اجتهاده صلى الله عليه وسلم في المصالح الدنيوية:
كثيرًا ما نستشف من بعض الآيات القرآنية أن الله تعالى عاتب نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم لاتخاذه بعضَ المواقف الإدارية والسياسية، مما يدلُّ على اجتهاده في كثيرٍ من القضايا، وحيث إن العتاب لم يوجَّه إلى اجتهاده بالخصوص، بل إلى ما أفضى إليه من نتائج، فذلك يعني جواز اجتهاده بدلالة الإمضاء الحاصل من قِبَل الله تعالى.
أما العتاب على النتائج، فيحمل بأنه إرشاديٌّ توجيهيٌّ؛ إذ بعضها على الأقل لا يدل على مخالفة النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأمر المولى عز وجل، أما البعض الآخر، فإن كان فيه ما يدلُّ على المخالفة، فهو محمول على الخطأ الذي لا يُقرُّ عليه[25].
كالذي جاء بخصوص ما عوتب عليه مع المؤمنين بعدم قتل أسرى بدر، كما في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: 67، 68]؛ لأن حكم الأسرى لم يشرع في ذلك الحين، وقد استشار أبا بكر وعمر، فأشار أبو بكر بأخذ الفداء، وخالفه عمر، وقد نزل الوحي مقرًّا لرأي عمر، وقال صلى الله عليه وسلم: ((لو نزل عذاب، ما نجا إلا عمر))، ومن هنا يتضح أن اجتهاد النبيِّ صلى الله عليه وسلم في النهاية راجعٌ إلى الوحي.
ومثله عتاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم على ما أذن للأعراب بالتخلُّف عن غزوة تبوك، كما في قوله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [التوبة: 43].
كما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مأمورٌ بالشورى في قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]، وهي تستلزم الاجتهاد؛ لأن نتائجها قد تخطئ الواقع في كل ما يتعلَّق بالمصالح الدنيوية.
ويؤيد ذلك ما ورد في الأحاديث والسيرة، وهو أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في قضايا تشخيص الواقع التي ينبني عليها تطبيق الأحكام وتنفيذها[26]، فهو بالتالي إمَّا مصيب أو مخطئ دون أن تكون له عصمة مطلقة شاملة.
روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحُجَّته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحقِّ، فإنما هي قطعةٌ من النار، فليأخذها أو يتركها))؛ البخاري 2534، ومسلم 1713.
وعن أنس بن مالك أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بقوم يلقحون النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لو لم تفعلوا لصلح))، فخرج شيصًا، فمرَّ بهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما لنخلكم؟))، قالوا: قلت: كذا وكذا، قال: ((أنتم أعلم بأمر دنياكم))؛ صحيح مسلم، حديث 2363.
المطلب الثاني: اجتهاده صلى الله عليه وسلم في المصالح الدينية:
هناك مَن جوَّز الاجتهاد على النبيِّ صلى الله عليه وسلم مطلقًا، سواء ما تعلَّق بالمصالح الدنيوية، أو ما ارتبط بالأحكام العامة من القضايا الدينية، مما لم يرد فيها نصٌّ، كما أن أكثر الأقوال الفقهية ترى النبيَّ صلى الله عليه وسلم مأمورًا بالاجتهاد مطلقًا، سواء في القضايا السياسية والحربية، أو في الأحكام الشرعية، والأمور الدنيوية، من غير تقييد شيء منها، معتبرًا أن ذلك مذهب عامَّة الأصوليين؛ كالشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل، وكذلك عامة أهل الحديث[27].
الأدلة من القرآن الكريم:
قال الله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: 2]؛ إذ رأوا أنها دالة على الاجتهاد والقياس، وهي عامة في حقِّ أولي الأبصار أو البصائر، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم أعظمهم بصيرة، لكن المتأمَّل - والله أعلم - في هذه الآية يجدها لا تدلُّ صراحةً على المقصود من الاجتهاد والقياس.
وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 83]، فوجه الدلالة أن الله عطف أولي الأمر على الرسول في وجوب الردِّ إليهم، ورتَّب ذلك العلم بحكم الشرع عن طريق الاستنباط، الذي هو الاجتهاد، فكما أجاز لهم ذلك، أجاز للنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
لكن ابن حزم اعترض على هذه الإفادة من المعنى، فاعتبر الضمير في لفظة (منهم) لا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، بل يرجع إلى الرادِّين، وبالتالي يكون المستنبطون منهم ليس هم أولي الأمر والرسولَ الكريم، وهو الظاهر على ما يبدو، لكن حتى مع اعتبار المستنبطين هم أولي الأمر والرسول الكريم، فإن الآية لا تدلُّ على الاجتهاد المفضي إلى الظن، بل تدلُّ على تحصيل العلم، سواء اعتبر ذلك اجتهادًا أو استخراجًا للمعنى، ومن المؤكَّد أن الحال في ذلك يختلف كليًّا عن الحال الذي يمارسه المجتهدون في طرقهم الاجتهادية[28].
كما استدلَّ العلماء على اجتهاد النبيِّ صلى الله عليه وسلم بآية: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: 7].
إذ قالوا بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو أَوْلى رسوخًا في العلم من غيره، لكن ليس للآية أيُّ دلالة واضحةٍ على الاجتهاد، والمقاصد الفقهية، ومن المحتمل أنها وردت بخصوص العقائد.
واستدلُّوا كذلك على اجتهاد النبيِّ صلى الله عليه وسلم بآية: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: 105]؛ إذ قيل: إن اللفظ بعمومه يتناول الحكم بالنص وبالاستنباط من النصِّ؛ إذ الحكم بكلٍّ منهما حكمٌ بما أراه الله، أو أن الحكم الذي يستنبط من المنزَّل هو حكم بالمنزَّل؛ لأنه حكم بمعناه.
بَيْدَ أنه إذا حملنا آلية الاستنباط على احتمال أنها تفضي إلى الخطأ، باعتبارها عملية الاجتهاد، فإنه لا يصح أن نعتبر الحكم الذي يستنبط من المنزَّل هو حكم بالمنزَّل أو بمعناه؛ وذلك لأنه يحتمل أن يكون خطأ، وظاهرُ الآية بعيد عن إرادة الاجتهاد المفضي إلى الظن، أو الذي يحتمل الخطأ، أو على الأقل إنه لا يدلُّ عليه؛ أما لو قيل: إن العموم في الآية يمكن أن يشمل الاستنباط من النصِّ، فيما لو كان مفضيًا إلى القطع واليقين، فلا مانع من ذلك باعتباره لا يختلف عن الحكم بالنصِّ[29].
الأدلة من السُّنَّة النبوية:
نقل العلماء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قوله: ((لولا أن أشقَّ على أُمَّتي، لأمرتُهم بالسواك مع كلِّ وضوء))، وفي رواية: ((عند كل صلاة))[30]؛ مما يعني أن الأمر بالسواك متروكٌ إلى اجتهاد النبيِّ الكريم وتقديرِه؛ لذلك لم يأمر به خوفَ المشقَّة على الناس، وهذا الحديث لا يدلُّ دلالةً صريحة على اجتهاد النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمعنى المتواضع عليه، فمن الجائز أن الله فوَّض له الأمر في ذلك، مثلما فوَّض إليه إرث الجدِّ أو الجدة.
ومن الجائز أيضًا أن يدلَّ هذا الحديث على الأمر الإرشاديِّ لا التعبُّدي.
كما استدلَّ العلماء بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حرم مكة: ((لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها))، قال العباس: إلا الإذخر، فقال النبيُّ الكريم: ((إلا الإذخر))[31]، فقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا النصِّ عن قطع حشيش حرم مكة وشجره، وأن موافقته للعباس على استثناء نبات الإذخر - ربما كما قيل لطيب رائحته - تدل على اجتهاده في أمر النهي والاستثناء؛ إذ من المستبعد أن يطابق كلام العباس ما أراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم قوله بالوحي[32].
وهذه الحادثة تدلُّ على المصالح الدنيوية التي يجوز فيها الاجتهاد من جهة تشخيص الواقع الموافق للمصلحة، وليس لها علاقة بالأحكام الكلية[33].
كما روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل: ((وفي بُضع أحدكم صدقة))، فقال أصحابه: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال صلى الله عليه وسلم: ((أرأيتم لو وضعها في حرام: أكان عليه فيه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))[34].
ومثله ما رواه ابن عباس من أن الجارية الخثعمية سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي أدركته فريضة الحجِّ شيخًا زمنًا لا يستطيع أن يحجَّ، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: ((أرأيت لو كان على أبيك دَيْن فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟))، قالت: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ((فدَينُ الله أحقُّ بالقضاء))[35].
والواضح من هذا الحديث أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم شَابَهَ بين قضيتين ربما لتقريب المعنى، ونفسها ما استدلَّ العلماء بما روي عن عمر بن الخطاب من أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اليوم - وهو صائم - أتيت أمرًا عظيمًا، فقال النبي الكريم: ((وما ذاك؟))، فقال: هششت إلى امرأتي فقبَّلتها، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مجَجْته، أكان عليك جناح؟))، قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: ((فلم إذًا؟))[36]؛ إذ قيل: إن في هذا النصِّ دلالةً على القياس؛ حيث قاس النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُقدِّمة الجِماع على مقدمة الشرب، فمثلما أن المضمضة لا تفسد الصوم، كذلك فإن القُبلة لا تفسده أيضًا، أو ربما شابه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين الأمرين للإيضاح لا التشريع[37].
كما أنه من الممكن أن يقع من النبيِّ صلى الله عليه وسلم قصد الشيء يريد به وجه الله تعالى، فيوافق خلاف مراد الله تعالى، وأنه تعالى لا يقرُّه على شيء من هذا أصلًا، بل ينبِّهه إلى ذلك إثر وقوعه منه، ويظهره لعباده، وربما عاتبه على ذلك بالكلام كما في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها وزيد بن حارثة، عندما توجَّه زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد تطليق زينب لسبب ذكَرَه له، فقال الرسول الكريم: ((أَمسِكْ عليك زوجك واتق الله))، فعاتبه على ذلك بقوله: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب: 37]، فرجع عما أمر به زيدًا مَوْلاه؛ لأن العرب جرت في عادتها ألا يتزوَّج الرجل زوج ولده المتبنَّى، ولما جاء الإسلام أباح أن يتزوج الرجل امرأة متبنَّاه المعروف الأب إذا طلَّقها أو مات عنها، ولما كانت عوائد العرب في مسائل النكاح حساسة جدًّا في هذه الناحية، وأراد الله إبطال عادتهم هذه بتشريع مبيح على وجه ملزم بالحلِّ، لكل من تحدِّثه نفسه بالتحلُّل منه، أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يزوِّج بنت عمَّته زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة، وأنه إذا طلَّقها زيد بعد ذلك يتزوَّجها صلى الله عليه وسلم؛ ليبطل تلك العادة بنفسه هو؛ حتى تكون قوة القدوة ماحقةً لقوة العادة[38].
,hrudm h[jih] hgvs,g wgn hggi ugdi ,sgl hgvs,g h[jih] ugdi ,hrudm
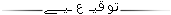
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
 تعليمات المشاركة
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 03:51 PM
|